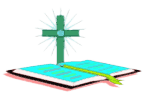|
دراسة الكتاب المقدس |
|
|
(تابع) الأصحاح السادس
بماذا نكافئ الرب مقابل كل عطاياه وإحساناته علينا؟
لا شكَّ أن محبة الله من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القوة هي أعظم جميع الوصايا؛ هكذا قال الرب يسوع، وهكذا شهد جميع القديسين. وكما هو مكتوب: "مياه كثيرة لا تستطيع أن تُطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تُحتقر احتقاراً" (نش 8: 7). وقد ختم القديس بولس أُنشودة المحبة التي نطق بها بإلهام الروح القدس بقوله: "أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة" (1كو 13: 13).
كما يقول القديس أوغسطينوس:
[وهكذا فإن الحكمة السامية الحقيقية هي تلك التي في الوصية الأولى: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. وبناءً على ذلك، فإن الحكمة هي "محبة الله التي انسكبت في قلوبكم - ليس بأي شيء آخر سوى - بالروح القدس المُعطَى لكم" (رو 5: 5). إلاَّ أنه مكتوب أنَّ "رأس الحكمة مخافة الرب" (مز 111: 10)، ولكنه مكتوب أيضاً "لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج" (1يو 4: 18)](1).
لذلك فإنه يضيف أيضاً قوله شارحاً علاقة المحبة بمخافة الله:
[عندما يتبقَّى أي أثر لشهوة الجسد، فإنه يلزم أن ينضبط الإنسان بزمام العفة (ومخافة الله) لكي يحب الله من كل النفس، لأن الجسد لا يشتهي بدون النفس، مع أن الجسد هو الذي يشتهي، لأن النفس لا تشتهي إلاَّ جسديّاً. أما في حالة الكمال، فإن الإنسان البار سيحيا بدون خطية، عندما لا يوجد في أعضائه ناموسٌ يُحارب ناموس ذهنه (رو 7: 23). وهكذا يمكنه أن يحب الله بكل كيانه، بكل قلبه، وبكل نفسه، وبكل فكره، التي هي الوصية الأولى والعظمى](2).
لذلك، بعد أن أوصى موسى بني إسرائيل بمحبة الله من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القوة، عاد يُحذِّرهم بقوله:
+ "ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يُعطيك، إلى مدن عظيمة جيدة لم تَبْنِها، وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها، وآبار محفورة لم تحفرها، وكروم وزيتون لم تغرسها، وأكلتَ وشبعتَ. فاحترز لئلا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. الرب إلهك تتَّقي، وإيـَّاه وحده تعبد، وباسمه تحلف" (تث 6: 10-13).
فهوذا هم مزمعون أن يدخلوا أرض الموعد التي حلف الرب لآبائهم أن يرثوها، ويبدأوا مرحلة جديدة من حياتهم، تتميز بتمتُّعهم بخيرات وفيرة لم يتعبوا فيها. فسوف يسكنون مدناً لم يبنوها، ويقطنون بيوتاً ملآنة خيرات لم يجمعوها، ويشربون من آبار لم يحفروها، ويأكلون من كروم وزيتون لم يغرسوه. ومن شيمة الإنسان أنه إذا أكل وشبع لا تنسيه النعمة مُعطيها ومَن له الفضل فيها، الله الذي أخرجهم بمحبته وقوته من أرض العبودية وأتى بهم إلى الرحب والسعة. لذلك يُحذِّرهم موسى من داء النسيان وإنكار فضل الله عليهم ونعمته التي يغمرهم بها، ويصف لهم الدواء الناجع القادر أن يحفظهم من هذا الداء إذا هم تمسكوا به وثابروا عليه. أما هذا الدواء فوصفه لهم هكذا بقوله: "فاحترز لئلا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. الرب إلهك تتَّقي، وإيـَّاه وحده تعبد، وباسمه تحلف" (تث 6: 13).
"الرب إلهك تتَّقي": "تتَّقي" من التقوى، وهي المخافة والرهبة. وقد تعلَّمنا من قول القديس أوغسطينوس - السالف الذكر - إن مخافة الله هي الجسر المؤدِّي إلى حبه، وهي الحارس الحافظ لمحبة الله. فإذا كان رأس الحكمة هو مخافة الله، فكمال الحكمة ومنتهى سعيها هو محبة الله. لذلك يقول مار فيلوكسينوس أسقف منبج بالعراق (+ 523م):
[إن هناك وصايا تُحفظ من الخوف، ووصايا تُحفظ من الحب. وباختصار نقول: إن كل وصايا العهد القديم تُحفظ بالخوف، ووصايا المسيح التي للعهد الجديد تُحفظ بالحب، كما قال سيِّدنا: "إن حفظتم وصايـــاي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قـد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته" (يو 15: 10). ومعروف أن الابن لا يحفظ وصايا أبيه من الخوف بل من الحب. وقد أمرنا نحن أيضاً أن نحفظ وصاياه من الحب، بأن قال: "إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيُعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد" (يو 14: 15)](3).
فإن كان موسى النبي قد أوصاهم أن يحبوا الله من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القدرة، فهذا هو منتهى قصد الله في محبته للبشر أن نبادله حبّاً بحب. ولكن لا يمكن أن نحبه حبّاً كاملاً إلاَّ بالروح القدس المُعطَى لنا، حسب وعد المسيح بأن يُرسله لنا لكي يمكث معنا إلى الأبد. لذلك يقول الأب متى المسكين في رسالة له عن المحبة التي سكبها الله في قلوبنا بالروح القدس المُعطَى لنا:
[المحبة التي سكبها الله في قلبنا صارت لنا بالحقيقة قوة حافظة ومُنعشة، نستطيع أن نغالب بها كل الظروف التي يسوقها العالم ضد إيماننا ورجائنا... المحبة حينما تتأصَّل في الحق تكون أشد صرامة من ناموس موسى، وتجعل الإنسان قادراً أن يبغض بُغضاً شديداً أشد من الموت، لأبيه وأُمه وإخوته حتى نفسه، حينما يُفترى عليها (أي على المحبة) ويُستغل اسمها ويُستهزأ بها ويُزيَّف حقُّها. المحبة كنار الممحِّص تنقِّي الإيمان من عوز المنفعة، وتصفِّي الرجاء من انتظار عائد الجهد، وتُغربل الصداقات من تفاهة العاطفة، وتراجع الصلات على نور القصد، وتعيد الفكر إلى مصدر مأمون، وتنتقد العمل حتى يستريح على قالب الحق...](4).
إذن، فإن لم تتأصل المحبة في الحق وتنبع من روح الحق الساكن فينا، فإنه لا يمكن أن يردع الإنسانَ عن السلوك في طريق البُعد عن الله شيءٌ سوى مخافة الله وذِكْر دينونته الرهيبة:
[لهذا تحرص الكتب المقدسة على الحض على اقتناء الخوف أكثر من الحب، لأن الخوف هو سبب الحب. فإن لم يزرع الإنسان بالخوف فلا يستطيع أن يحصد بالحب، لأن الخوف يتبعه الاحتراس، أما الحب فيُلازمه الثقة والاتكال](5).
من أجل هذا نجد موسى النبي يحث بني إسرائيل قائلاً: "الرب إلهك تتَّقي، وإياه تعبد، وباسمه تحلف". فلا يكفي أن تتَّقي الله وتخافه دون أن تعبده وتتعبَّد له. وقد جاءت هذه الكلمة: "إياه تعبد" في ترجمات أخرى: "وبه تلتصق"، وأيضاً: "وإياه تخدم". والمعنى واحد، لأن عبادة الرب تستلزم الالتصاق به وخدمته بالخضوع لأوامره والعمل بوصاياه وفرائضه. وقد أجاب الرب يسوع إبليسَ حينما عرض عليه أن يسجد له بقوله: "اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد" (مت 4: 10)، وهو نفس قول الرب في سفر التثنية في هذا الموضع وفي (تث 10: 20).
أما قوله "وباسمه تحلف"، فباعتبار ذلك إعلاناً لانتمائهم لإلههم الواحد الذي يعبدونه في وسط شعوبٍ تعبد الأصنام؛ فحلفهم باسمه هو إقرارهم بولائهم له وحده، واعترافهم باسمه أمام الأمم، وتمسُّكهم به وثباتهم فيه، بشرط ألاَّ يحلفوا باسمه باطلاً.
خطورة التهاون في الالتصاق بالله والتمسُّك باسمه:
+ "لا تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأُمم التي حولكم. لأن الرب إلهكم إلهٌ غيور في وسطكم، لئلا يَحْمَى غضب الرب إلهكم عليكم فيُبيدكم عن وجه الأرض. لا تُجرِّبوا الربَّ إلهكم كما جرَّبتموه في مَسَّة" (تث 6: 14-16).
إن النتيجة الحتمية للتهاون في السير بخوف الله، والالتصاق به، والتمسُّك باسمه، وحفظ وصاياه؛ سوف يؤدِّي بهم إلى السير وراء آلهة الأُمم الذين حولهم، واتِّباع ضلالاتهم والتنكُّر للإله الحي الذي أحبهم واختارهم وأنقذهم من العبودية، وخلَّصهم من نير الفرعون، وأتى بهم إلى هذه الأرض الجيدة، لكي يرثوها ويتمتعوا بخيراتها.
وهذا هو ما حدث بالفعل، بكل أسف، فقد أَلْهتهم خيرات الأرض الجيدة عن عبادة الرب إلههم، وسرعان ما ذهبت نذورهم وتعهُّداتهم التي أخذوها على أنفسهم هباءً منثوراً: "وعبد الشعب الرب كل أيام يشوع، وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع، الذين رأوا كل عمل الرب العظيم الذي عمل لإسرائيل... وكل ذلك الجيل أيضاً انضم إلى آبائه، وقام بعدهم جيل آخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لإسرائيل. وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم، وتركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم، وسجدوا لها وأغاظوا الرب، وتركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت" (قض 2: 7-13).
وينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا هذا الأمر الواقع، وهو أن غرض الرب من سرد تاريخ إسرائيل هو أن تستفيد كنيسة الله من هذا التاريخ، وتستخرج لنفسها دروساً منه: "لأن كل ما سبق فكُتب كُتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء" (رو 15: 4). كما يقول أيضاً القديس بولس الرسول في موضع آخر: "فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالاً، وكُتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن مَن يظن أنه قائم، فلينظر أن لا يسقط" (1كو 10: 12،11).
فإن كان بنو إسرائيل قد تركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم. فالكتاب يُحذِّرنا نحن أيضاً لئلا تثقل قلوبنا بهموم هذا العالم وغرور الغِنَى وشهوات سائر الأشياء، وننسى الله مخلِّصنا الذي أحبنا وفدانا واشترانا بدمه لنكون له أُمة مقدسة وشعباً مُبرَّراً، لأن "الروح يقول صريحاً: إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحاً مُضلَّة وتعاليم شياطين، في رياء أقوال كاذبة، موسومة ضمائرهم..." (1تي 4: 2،1).
ويُكرِّر القديس بولس الرسول تحذيره أيضاً قائلاً في رسالته الثانية لتلميذه تيموثاوس:
+ "ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون مُحبين لأنفسهم، مُحبين للمال، متعظِّمين، مستكبرين، مجدِّفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضًى، ثالبين، عديمي النزاهة، شرسين، غير مُحبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلِّفين، مُحبِّين للَّذَّات دون محبة الله، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوَّتها" (2تي 3: 1-5).
+ "لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم مُعلِّمين مستحِكَّة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات" (2تي 4: 4،3).
أليس هذا هو حالنا الآن في هذه الأزمنة الصعبة؟! أَلاَ يحق لنا أن نصرخ مع بولس الرسول مُحذِّرين ومنذرين من أجل أولئك الذين يرتدُّون عن الإيمان، تابعين أرواحاً مُضلَّة وتعاليم شياطين، في رياء أقوال كاذبة؟! ومن أجل الذين لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها؟! ومن أجل الذين لا يحتملون التعليم الصحيح بل يصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات؟! بل ومن أجل أنفسنا نحن أيضاً الذين من أجل كثرة الإثم قد بردت محبتنا؟!
إن الأمر جدُّ خطير، لأن محبة الله لنا التي وصلت إلى المنتهى إلى حدِّ أنه قد بذل ابنه الوحيد لأجلنا: "لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل مَن يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية" (يو 3: 16)، هذه المحبة الفائقة لابد أن يترتب عليها غيرة شديدة من قِبَل الله نحو محبوبيه. فهو لا يطيق أن يراهم وقد تركوا الإله الحي الذي أحبهم وفداهم وذهبوا وراء آلهة غريبة، ووراء شهوات نفوسهم: "ابهتي أيتها السموات من هذا، واقشعري جداً، يقول الرب، لأن شعبي عمل شرَّين: تركوني أنا ينبوع المياه الحيَّة، لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشقَّقة لا تضبط ماءً" (إر 2: 13،12).
لقد اقترن الله بشعبه اقتران عريس بعروس، وأحب المسيح الكنيسة واتحد بها فصرنا أعضاء في جسده، "لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه" (أف 5: 3)؛ لذلك فإنَّ غيرة الرب علينا عظيمة، كما كان يغار على شعبه إسرائيل قائلاً: "لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم، لئلا يحمى غضب الرب عليكم، فيبيدكم عن وجه الأرض"، وكما قال أيضاً على لسان هوشع النبي:
+ "وقال الرب لي: اذهب أيضاً أحبب امرأةً حبيبة صاحبٍ وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل، وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب... لا تفرح يا إسرائيل طرباً كالشعوب، لأنك قد زنيت عن إلهك... ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك، لأنك قد تعثَّرت بإثمك... أنا أشفي ارتدادهم، أحبهم فضلاً لأن غضبي قد ارتدَّ عنه" (هو 3: 1؛ 9: 1؛ 14: 4،1).
وكما قال أيضاً بولس الرسول:
+ "فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأُقدِّم عذراء عفيفة للمسيح" (2كو 11: 2).
ثم يعود فيقول لنا محذِّراً:
+ "فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف، وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين... مخيفٌ هو الوقوع في يدي الله الحي" (عب 10: 31،27،26).
ويقول سفر نشيد الأنشاد:
+ "لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب. مياه كثيرة لا تستطيع أن تُطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها" (نش 8: 7،6).
أما موسى النبي فإنه يعود أيضاً فيُحذِّرهم من تجربة الرب كما جرَّبوه من قبل في مَسَّة. و"مَسَّة" هو اسم المكان الذي أُطلق على الموضع الذي جرَّبوا فيه الرب في البرية بالقرب من رفيديم، ومعناه "تجربة". لأن الشعب تذمر هناك على موسى وعلى الرب للمرة الثالثة منذ خروجهم من مصر قائلين: "أفي وسطنا الرب أم لا؟" (خر 17: 7)
وقد تركت فداحة هذه الخصومة والتذمُّر أثراً لا يُمحَى في ذاكرة وتاريخ بني إسرائيل على مدى الدهور، حتى أنه تكرر ذِكْر هذه الحادثة في الأسفار المقدسة مرات عديدة. فهوذا هنا يُذكِّرهم موسى بهذه الحادثة، ويُكررها مرة أخرى في (تث 9: 22)، مُعدِّداً لهم المرات التي أسخطوا فيها الرب قائلاً: "وفي تبعيرة ومَسَّة وقبروت هتَّأوة أسخطتم الرب".
أما في سفر المزامير فيقول لهم الروح مُحذِّراً: "اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسُّوا قلوبكم، كما في مريبة، مثل يوم مَسَّة في البرية، حيث جرَّبني آباؤكم، اختبروني، أبصروا أيضاً فعلي. أربعين سنة مقتُّ ذلك الجيل..." (مز 95: 7-10).
(يتبع)
(1) St. Augustine, Letter 140,18; FC 20:95-96. (2) St. Augustine, On the Perfection of Human Righteousness 8,19; NPNF 15:165. (3) مار فيلوكسينوس المنبجي، "الآباء الحاذقون في العبادة"، الجزء الأول، ص 90. (4) كتاب: "رسائل القمص متى المسكين"، الرسالة (93)، ص 381-382. (5) مار فيلوكسينوس المنبجي، "الآباء الحاذقون في العبادة"، الجزء الأول، ص 20.