|
دراسة الكتاب المقدس
|
|
|
(تابع) سنة الإبراء (15: 12-18)
إطلاق العبيد أحراراً في السنة السابعة، سنة الإبراء:
ما زلنا في حديثنا عن سنة الإبراء التي بدأ الأصحاح الخامس عشر بالتحدُّث عنها قائلاً: «في آخر سبع سنين تعمل إبراءً». وكان أول حُكْمٍ للإبراء، الذي يعني ”العِتْق، أو الإطلاق، أو التحرير، أو الصفح“، هو التنازل عن الديون، بمعنى أن لا يُطالب كل صاحب دَين من أقرضه بالدين الذي له عليه. وقد حلَّت أول سنة للإبراء في أرض الموعد بعد مُضيِّ واحد وعشرين سنة من دخول بني إسرائيل لأرض كنعان، كما ذكر التقليد(1). فمنذ بداية إخضاعهم لأرض كنعان حتى نهاية امتلاكهم لها استغرق ذلك سبع سنين. كما أن تقسيم الأرض بين الأسباط استغرق سبع سنين أخرى. وهكذا فإنه لم يتم تقديم العشور للرب من كل ما تنبت الأرض إلاَّ بعد مُضيِّ أربع عشرة سنة من دخولهم أرض كنعان. وبذلك، كما ذكرنا سابقاً، فإن أول سنة سبتية حفظوها كانت بعد سبع سنين أخرى، وهذه السنة التي سُمِّيت هنا في سفر التثنية بسنة الإبراء.
أما الحُكْم الثاني الواجب مراعاته في سنة الإبراء، فهو إطلاق العبيد أحراراً:
+ «إذا بـِيع لك أخوك العبرانيُّ أو أختك العبرانية، وخدمك ستَّ سنين، ففي السنة السابعة تُطلقه حُرّاً من عندك. وحين تُطلقه حُرّ اً من عندك لا تُطلقه فارغاً. تُزوِّده من غنمك ومن بَيْدَرك ومن مَعْصرتك. كما باركك الرب إلهك تُعطيه. واذكر أنك كنتَ عبداً في أرض مصر ففداك الرب إلهك. لذلك أنا أُوصيك بهذا الأمر اليوم. ولكن إذا قال لك لا أخرج من عندك، لأنه قد أحبَّك وبيتك، إذ كان له خيرٌ عندك. فخُذ المِخْرز واجعله في أُذنه وفي الباب، فيكون لك عبداً مؤبَّداً. وهكذا تفعل لأَمَتِك أيضاً. لا يصعب عليك أن تُطلقه حُرّاً من عندك، لأنه ضِعْفَي أُجرة الأجير خدمك ستَّ سنين، فيُباركك الرب إلهك في كل ما تعمل» (15: 12-18).
من الأمور الملفتة للنظر أن أول أحكام عهد سيناء، التي جاءت في الأصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج، كانت تختص بأدنى طبقات المجتمع، وهم العبيد المشترون بالمال وحقوقهم التي يلزم مراعاتها لدى أسيادهم، والتوصية بتحريرهم في السنة السابعة. وهنا أيضاً في سفر التثنية يُعيد موسى عليهم نفس هذا الحُكْم ثانيةً، مؤكِّداً لهم أنه أمرٌ يهمُّ الله للغاية، حتى أنه بسببه يُباركهم الرب إلههم في كل ما يعملون. والواقع أنه لا يوجد لهذه الأحكام مثيل في أيِّ قانون وضعي من قوانين العالم، إلاَّ مؤخَّراً بعد عصور النهضة الحديثة، وبسبب التأثير العميق الذي طبعته وصايا المسيح في قلوب المؤمنين باسمه، حتى صار أمراً طبيعياً الآن أن يُنادَى بحقوق الإنسان وبتجريم المتاجرة بالبشر.
وإن كان اقتناء العبيد أمراً سائداً في العالم القديم، يستوي في ذلك الأُمم الوثنية مع الشعب اليهودي، إلاَّ أن العبودية عند العبرانيين كانت تتم تحت ظروف معينة: إما بسبب الفقر قد يبيع الإنسان نفسه تسديداً لدين (لا 25: 39)، أو أولاده (2مل 4: 1)، أو بسبب السرقة: «إن لم يكن له (ما يُعوِّض به عن سرقته) يُبعْ بسرقته» (خر 22: 3).
هذا بخصوص العبيد العبرانيين، ولكنهم كانوا يأخذون لهم أيضاً عبيداً من الشعوب الذين حولهم (لا 25: 45،44)، إلاَّ أنه كانت تحكمهم قوانين وأحكام إلهية مؤسَّسة على المساواة بين جميع البشر الذين خلقهم الله جميعاً على صورته ومثاله، وخلقهم أحراراً. فالعبد أخٌ لسيِّده في الإنسانية وشريكٌ معه في العبودية للإله الواحد. لذلك ينبغي أن يُعامل كأخ: «إذا افتقر أخوك عندك وبِيعَ لك، فلا تستعبده استعباد عبدٍ. كأجير كنزيل يكون عندك... لا تتسلط عليه بعنف، اخشَ إلهك» (لا 25: 39-43). كما يدعوه هنا أيضاً على أنه أخ أو أخت: «إذا بِيْع لك أخوك العبراني، أو أختك العبرانية...» (تث 15: 12). كما يُذكِّره الرب هنا أيضاً قائلاً: «واذكر أنك كنتَ عبداً في أرض مصر، ففداك الرب إلهك. لذلك أوصيك بهذا الأمر اليوم» (15: 15). فكما كنتَ عبداً وأعتقك الرب إلهك وفداك من العبودية فعليك أن تعتق أخاك الذي استُعبد لك. وليس هذا فحسب، بل تنص هذه الأحكام بضرورة تحرير العبيد في السنة السابعة من عبوديتهم، كما جاء في سفر الخروج: «إذا اشتريت عبداً عبرانياً، فستَّ سنين يخدم، وفي السنة السابعة يخرج حُرّاً مجاناً...» (خر 21: 2-6).
أما هنا في سفر التثنية فتكاد تكون نفس التوصية، إلاَّ أنه إذا حلَّت السنة السبتية، سنة الإبراء قبل ست سنواتٍ خدمة للعبد، كان يُطلَق سراحه كذلك، كما يوصيه الرب أيضاً قائلاً:
+ «وحين تُطلقه حُرّاًَ من عندك لا تُطلقه فارغاً. تزوِّده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك، كما باركك الرب إلهك تُعطيه» (15: 13).
ويظهر هنا من هذه التوصية مقدار لطف الله ورحمته واهتمامه بهذا العبد الذي يُطلقه سيده حُرّاً بعد انتهاء مدة خدمته، فلابد أن يزوِّد ذلك السيد عبده بما يُساعده على أن يبدأ حياة جديدة كريمة، فيهبه من الخيرات التي أنعم الله عليه بها على قدر ما باركه الله. أما إذا اختار ذلك العبد الاستمرار والبقاء في خدمة سيده، لأن قلبه قد تعلَّق بمحبة سيده، وقد كان له خير عنده بما لاقاه من حُسن المعاملة، فكان على السيد في هذه الحالة أن يقوم بعمل احتفالٍ رمزي يمثِّل إبرام عقد ارتباطٍ مع عبده الذي ارتضى أن يصير واحداً من أفراد أسرته، فيأخذه ويوقفه عند باب داره، ويجعل المخرز في شُحمة أُذنه وفي الباب، علامةً على قبوله بمحض حريته أن لا يُفارقه مدى حياته. وهكذا يفعل مع أَمته إذا ارتضت أيضاً أن لا تفارقه.
أما قول الرب: «لا يصعب عليك أن تُطلقه حُرّاً من عندك، لأنه ضِعْفَي أُجرة الأجير خدمك ستَّ سنين، فيُباركك الرب إلهك في كل ما تعمل» (15: 18)؛ فقد جاءت في الترجمة الحديثة هكذا: «لا تأسف أن تطلقه حُرّاً من عندك، فهو كان يستحق ضعف أُجرة أجيرٍ لخدمته لك ست سنين، فيُباركك الرب إلهك في جميع ما تعمله».
وهنا يظهر جليّاً مدى اهتمام الله، ليس فقط بالحضِّ على عمل الخير بإطلاق العبد حُرّاً في سنة الإبراء، وإنما أيضاً بكيفية أدائه. فالله لا يكفيه مجرد إتمام العمل الحسن وفقاً للشروط التي أمر بها، ولكنه يودُّ أن نقوم بأدائه بكيفية تُدخِل الفرح والسرور لقلب من أحسنَّا إليه؛ كما ينبغي أيضاً أن نعمل الخير بكيفية تؤكِّد للآخِذ أن قلوبنا قد امتلأت فرحاً وسروراً بهذا العمل، تنفيذاً لقول الرب: «المعطي المسرور يحبه الله» (2كو 7: 9).
فالله هنا يُخاطب ضمير الإنسان المعطي، راجياً أن يكون عطاؤه وإطلاقه لعبده حُرّاً بقلبٍ راضٍ مستريح. ولا يظن في نفسه حينما يُطلق ذلك العبد الذي خدمه ست سنين مجاناً، وزوَّده ببعض من الخيرات التي أنعم عليه الله بها حينما أطلقه، أنه قد فعل شيئاً عظيماً، فعليه أن يتذكر أن ذلك العبد قد خدمه ست سنين بلا مقابل، وأنه كان يستحق عليها ضعف أجرة أجيرٍ لو استأجره، عدا كونه مُخْلِص ومستديم طوال هذه السنين. وبعد أن يقنعه الرب ويشجِّعه على عمل الصلاح والإحسان لأخيه الإنسان، يعده بالبركة في كل ما تمتد إليه يده، إذا عمل بما أوصى به الرب.
تقديس أبكار الحيوانات للرب: (15: 19-23)
أول ذِكْر لتقديس أبكار الحيوانات للرب، كان في سفر الخروج (13: 2،1، 11-15) حيث يقول الرب لموسى: «وكلَّم الرب موسى قائلاً: قدِّس لي كلَّ بِكْر كل فاتح رَحِم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم، إنه لي... ويكون متى أدخلك الربُّ أرض الكنعانيين كما حلف لك ولآبائك، وأعطاكَ إيَّاها، أنك تُقدِّم للرب كل فاتح رَحِم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك، الذكور للرب. ولكن كل بِكر حمارٍ تفديه بشاة. وإن لم تَفْدِه فتكسر عُنقه. وكل بكر إنسان من أولادك تَفديه. ويكون متى سألك ابنك غداً قائلاً: ما هذا؟ تقول له: بيدٍ قوية أخرجنا الربُّ من مصر من بيت العبودية. وكان لما تقسَّى فرعون عن إطلاقنا أن الرب قَتَلَ كل بكر في أرض مصر من بكر الناس إلى بكر البهائم. لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رَحِم، وأفدي كل بِكر من أولادي».
وهنا يُعيد موسى على أسماع الشعب نفس هذه الوصية لأهميتها، وهم على أعتاب أرض كنعان قبل دخولها، فيقول لهم:
+ «كل بكْر يولد من بقرك ومن غنمك تُقدِّسه للرب إلهك. لا تشتغل على بكر بقرك ولا تَجُزَّ بكر غنمك. أمام الرب إلهك تأكله سنةً بسنةٍ في المكان الذي يختاره الرب أنت وبيتك. ولكن إذا كان فيه عيبٌ أو عَمَى عيبٌ ما رديٌّ، فلا تذبحه للرب إلهك. في أبوابك تأكله، النجس والطاهر سواءً كالظَّبي والأُيَّل. وأما دمه فلا تأكله، على الأرض تسفكه كالماء» (15: 19-23).
فتقديس الأبكار، إذن، يعود أساساً إلى فداء أبكار بني إسرائيل - من الناس ومن البهائم - من الموت مع أبكار المصريين، يوم أخرجهم الرب بيد قوية من أرض مصر من بيت العبودية. لأن حُكْم الموت كان مستوجباً على الجميع، فقد دخلت الخطية إلى العالم بتعدِّي آدم: «وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع» (رو 5: 12). ولكن الله بنعمته خلَّص إسرائيل حينذاك من الموت مع أبكار المصريين، وفداهم بدم خروف الفصح، إشارة إلى خلاصه الشامل لكل البشرية الذي كان مزمعاً أن يُكمِّله في ملء الزمان بموته على الصليب.
ومن الطبيعي أن يصبح المفديُّون مِلْكاً خاصاً للذي فداهم، لذلك أمر الرب شعبه أن يُقدِّس له كل بكر فداه من الموت من الناس ومن البهائم. ولم يكن هذا إلاَّ تنبيهاً لأذهاننا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور لكي «نحسب هذا، أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع، فالجميع إذن ماتوا. وهو (المسيح) مات لأجل الجميع، كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم، بل للذي مات لأجلهم وقام» (2كو 5: 15،14).
إذن، فتقديس الأبكار للرب كان رمزاً لتقديس كل المفديين بدم المسيح الذين صاروا «كنيسة أبكار مكتوبين في السموات» (عب 12: 23).
ولكن لا إسرائيل كبكر بين الشعوب، ولا الأبكار فاتحي الرحم في كل أسرة من بين إسرائيل، استطاعوا أن يكونوا قدساً للرب! فاختار الرب اللاويين لخدمته ليكونوا عِوَضاً عن كل أبكار الشعب، ولا هؤلاء أيضاً استطاعوا أن يُقدِّسوا أنفسهم لله.
أما الابن الوحيد من الآب الذي استطاع أن يكون قُدساً للرب هو الرب يسوع، الذي دُعِيَ بحقٍّ ”الابن البكر“، كقول القديس غريغوريوس النيصي، مُعدِّداً المرات التي دعا فيها بولس الرسول الرب يسوع بكراً:
[يستخدم الرسول المُلهم لقب ”الابن البكر“ في أربع مناسبات، فيدعوه مرة قائلاً: «بكر كل خليقة» (كو 1: 15)، وفي مرة أخرى: «ليكون هو بكراً بين إخوة كثيرين» (رو 8: 29)، وأيضاً: ”بكر من الأموات“ (كو 1: 18)، وفي مناسبة أخرى يستخدم اللقب بصفة مطلقة دون أن يربطه بأيِّ كلمات أخرى قائلاً: «وأيضاً متى أَدْخَلَ البكر إلى العالم، يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله» (عب 1: 6)...](2).
+ ولكي يتطابق الرمز مع المرموز إليه في شريعة تقديس الأبكار للرب، نلاحظ أن ذكور الأبكار من البهائم الطاهرة هي التي تُذبح للرب، لأن تقديم الذكر للرب يشير إلى كمال التقدمة، ويلزم أن تكون طاهرة رمزاً لحَمَل الله القدوس الطاهر الذي حَمَل خطية العالم. أما ذكور الأبكار من البهائم غير الطاهرة - مثل الحمار - فتُفتدى بشاةٍ أو تُكسر رقابها.
+ وما دامت الأبكار قُدساً للرب، فلا يجب أن يشتغلوا عليها في الحقل أو في أيِّ عمل آخر. ويرى بعض المفسِّرين أن هذا يعني أيضاً أنه يجب أن لا يشتغلوا حتى على الأنثى إذا كانت بكراً. كما يجب ألاَّ تُجزُّ أبكار الأغنام، لأنه لا يجوز لهم أن ينتفعوا بصوفها لأنها مِلكٌ للرب. كما ذُكر أيضاً في سفر اللاويين أنه لا يجوز أن تُقدَّم الأبكار كنذر للرب، لأنها لا تعدُّ ملكاً لصاحبها.
+ كما أن هذه الأبكار من الحيوانات الطاهرة، كانت تُحمل إلى المكان المقدس الذي فيه هيكل الرب وتُذبح وتؤكل هناك أمام الرب، سنةً بسنةٍ، وذلك حسب ما أوصى به الرب من قبل بقوله: «لا يحلُّ لك أن تأكل في أبوابك عُشر حنطتك وخمرك وزيتك، ولا أبكار بقرك وغنمك، ولا شيئاً من نذورك التي تنذر ونوافلك ورفائع يدك» (تث 12: 17). «وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره ليحلَّ اسمه فيه عُشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك، لتتعلَّم أن تتقي الرب إلهك كل الأيام» (تث 14: 23).
ولا شكَّ أن قصد الرب من ذلك أن يربطهم بالرب الواحد الذي عرفوه مُخلِّصاً وفادياً لهم، والذي سمعوا صوته يُكلِّمهم من فوق جبل سيناء، وهو الذي أخرجهم من مصر أرض العبودية، وأتى بهم إلى أرض الموعد؛ فعليهم أن يأتوا إليه في المكان الذي يختاره ليحلَّ اسمه فيه، ويمثلوا في حضرته، حاملين عشورهم وبكورهم، ويأكلوا معاً أمامه من كل ما تصل إليه أيديهم من بركات الرب عليهم. وهكذا يصير الجميع في شركة واحدة وبقلب واحد، وفرح وابتهاج بالرب الواحد.
+ كما ينبغي أن تكون هذه الأبكار بلا عيب، «عرج أو عَمَى أو عيب ما رديٌّ»، فلا ينبغي أن تُذبح للرب، وذلك حسب ما أوصى به الرب من قبل بقوله: «كل ما كان فيه عيب لا تقربوه، لأنه لا يكون للرضا عنكم» (لا 22: 20). «ومرضوض الخصية ومسحوقها ومقطوعها لا تُقرِّبوا للرب. وفي أرضكم لا تعملوها» (لا 22: 24). «لا تذبح للرب إلهك ثوراً أو شاة فيه عيب، شيء ما رديٌّ، لأن ذلك رجس لدى الرب إلهك» (تث 17: 1). «وإن قربتم الأعمى ذبيحة، أفليس ذلك شرّاً؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم، أفليس ذلك شرّاً؟ قرِّبه لواليك، أفيرضى عليك، أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود» (ملا 1: 8).
ومن الواضح أيضاً أن قصد الرب من ذلك أن هذه الذبائح تشير إلى الرب يسوع البكر الوحيد الحقيقي، وحَمَل الله الذي بلا عيب.
أما إذا كان في هذه الأبكار عيب، فمن المصرَّح ذبحها وأكلها في بيوتهم وفي مدنهم، وتكون معاملتها مثل الحيوانات الأخرى التي لا يصلح تقديمها ذبائح للرب كالظبي والأُيَّل، على ألاَّ يأكلوا دمها، بل يسكبوه على الأرض، كما سبق وأوصى الرب بذلك: «وكل دم لا تأكلوا في جميع مساكنكم من الطير ومن البهائم» (لا 7: 26). «وأما الدم فلا تأكله، على الأرض تسفكه كالماء» (تث 12: 16). «ولكن احترز أن لا تأكل الدم لأن الدم هو النفس، فلا تأكل النفس مع اللحم» (تث 12: 23).
وقد سبق أن ذكرنا قولاً للقديس كليمندس الإسكندري عن قدسيَّة الدم، يُعلِّل فيه سبب قول الرب في العهد القديم: إن «الدم هو النفس»، ولماذا لم يكن مصرَّحاً أكله في العهد القديم:
[... فقد جيء بنا إلى الوحدة مع المسيح في علاقتنا به من خلال الدم الذي بواسطته قد افتُدينا، وإلى الشركة معه كنتيجة للتغذية التي تسري من الكلمة (ومن خلال جسده ودمه الأقدسين في سر الإفخارستيا)؛ وإلى الخلود من خلال قيادته لنا (بالروح القدس الساكن فينا)](3).
(يتبع)
(1) A. Edersheim, The Temple, The Sabbatical Year, Chap. IX, p. 189-194.
(2) Against Eunomius, Book II, 8.
(3) Clement of Alexandria, Paedagogus, Book I, Chap. VI (ANF, Vol. VII, p. 221,222).

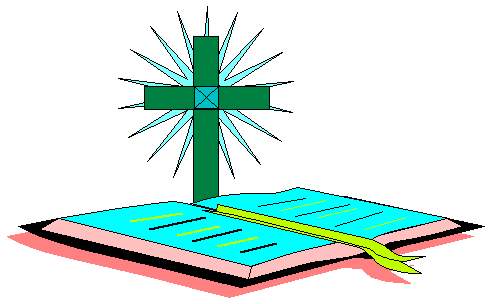 الأصحاح الخامس عشر
الأصحاح الخامس عشر