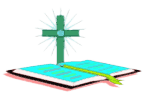|
دراسة الكتاب المقدس |
|
|
استطرد موسى في حديثه الثاني لشعب إسرائيل عمَّا يتوقَّعه الرب من إسرائيل بقوله:
+ «وهذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن أُعلِّمكم لتعملوها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها، لكي تتَّقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائضه ووصاياه التي أنا أُوصيك بها أنت وابنك وابن ابنك كل أيام حياتك، ولكي تطول أيامك. فاسمع يا إسرائيل واحترز لتعمل لكي يكون لك خيرٌ وتكثُر جداً كما كلَّمك الرب إله آبائك في أرضٍ تفيض لبناً وعسلاً» (تث 6: 1-3).
هذه الآيات الثلاث تُعتبر مُقدِّمة للفقرة التي تليها والتي تمثِّل أعظم ما نطق به موسى في خطابه الوداعي لبني إسرائيل، وهو الذي أسماه الرب يسوع: «الوصية الأولى والعُظمى» (مر 12: 29-30؛ لو 10: 27).
ويبدأ موسى تمهيده لذِكْر هذه ”الوصية الأولى والعظمى“ بقوله: «هذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن أُعلِّمكم لتعملوها». ومما يلفت النظر أن كلمة ”الوصايا“ قد جاءت مُفردة في اللغة العبرية، أي أنها ذُكِرَت هكذا: ”هذه هي الوصية والفرائض والأحكام“. ولعلها بذلك تشير إلى الوصية الأولى والعظمى التي تحوي كل الناموس، حيث تصبح الفرائض والأحكام في المقابل مُعبِّرةً عن كل ما يتضمنه الناموس المؤسَّس على هذه الوصية الأولى والعظمى. وقد كلَّف الرب موسى بأن يُعلِّمهم إيـَّاها ليعملوا بها في الأرض التي هم عابرون إليها ليمتلكوها، لكي يتَّقوا الرب إلههم ويحرصوا على إرضائه بإطاعة وصاياه وحِفْظ جميع فرائضه وأحكامه، في جيلهم وجيل أبنائهم وأبناء أبنائهم، لكي تطول أيامهم في تلك الأرض التي «تفيض لبناً وعسلاً».
وقد جاء وصف تلك الأرض التي هم مزمعون على امتلاكها بهذا الوصف مرات كثيرة في سفر التثنية (6: 3؛ 11: 9؛ 27: 30؛ 31: 20)، لكي يذكروا دائماً فضل الرب عليهم في كل عطاياه لهم، ولكي يحذروا من أن تلهيهم خيرات هذه الأرض عن الرب إلههم الذي أحبهم والذي أغدق عليهم بها لكي يشكروه ويلهجوا بفضله كل حين.
والآن نأتي إلى الوصية الأولى والعُظمى:
+ «اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا ربٌّ واحد. فتُحِبُّ الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوَّتك» (تث 6: 5،4).
هذه هي خلاصة اللوح الأول الذي للوصايا العشر، الذي يتضمن الوصايا الأربع الأولى المختصة بعلاقتهم بالله. ولهذا اعتبرها الرب يسوع الوصية الأولى والعظمى، ويُسمِّيها اليهود: ”الشِّمَاع“، بمعنى: ”اسمع“، التي بدأت بها الوصية: «اسمع يا إسرائيل».
ويُعلِّق القديس أمبروسيوس أسقف ميلان (339-397م) على القول: «اسمع يا إسرائيل» قائلاً:
[يقول الناموس: «اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك الرب واحد». فهو لم يَقُل: ”تكلَّم“ بل ”اسمع“. لقد سقطت حواء لأنها تكلَّمت مع آدم بما لم تسمعه من الرب إلهها. فأول كلمة من الله (لبني إسرائيل) تقول لك: ”اسمع“](1).
والسمع هنا - كما قلنا سابقاً في بداية الأصحاح الخامس - يفيد الطاعة والإذعان والفهم والتعلُّم والحفظ في القلب والعمل بما تعلَّمناه. وكما سبق أن ذكرنا في بداية الأصحاح الرابع أن هذا التعبير سوف يُقابلنا كثيراً على مدى سفر التثنية بصيغ متعددة، لأن هذا هو سبيل الحياة مع الله على مدى الكتاب كله؛ والذي عبَّر عنه الرب يسوع بمثل الزارع، وعلَّق عليه بقوله لتلاميذه مُفسِّراً لهم نبوَّة إشعياء القائلة: «اذهب وقُل لهذا الشعب: اسمعوا سمعاً ولا تفهموا، وأبصروا إبصاراً ولا تعرفوا. غلِّظ قلب هذا الشعب وثقِّل أُذنيه واطمس عينيه، لئلا يُبصر بعينيه ويسمع بأُذنيه ويفهم بقلبه ويرجع، فيُشفَى» (إش 6: 10،9). وفسَّره الرب قائلاً: «لأنهم مُبصرين لا يُبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. فقد تمَّت فيهم نبوَّة إشعياء القائلة: تسمعون سمعاً ولا تفهمون، ومُبصرون تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وآذانهم قد ثقل سماعها. وغمَّضوا عيونهم، لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم، ويرجعوا فأشفيهم. ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع» (مت 13: 13-16).
ويتضح أيضاً معنى السمع الذي يقصده الله وينتظره منا من قوله: «مَن له أُذنان للسمع فليسمع» (مت 11: 15؛ لو 8: 8). وقد جاءت بأكثر وضوح في سفر الرؤيا هكذا: «مَن له أُذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس» (رؤ 2: 29،17،11،7؛ 3: 22،13،6)، حيث يفيد السمع هنا انفتاح الذهن لِمَا يُسِرُّه الروح للنفوس المستعدَّة لقبول مشيئة الله والعمل بها.
كما خاطب الرب يسوع أولئك اليهود الذين سدُّوا آذانهم عن سماع صوته ورفضوا الإيمان به قائلاً: «لا يقدر أحد أن يُقبـِل إليَّ إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني وأنا أُقيمه في اليوم الأخير. إنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلِّمين من الله. فكل مَن سمع من الآب وتعلَّم يُقبـِل إليَّ» (يو 6: 45،44). كما قال لهم أيضاً: «خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها، فتتبعني» (يو 10: 27).
الرب إلهنا ربٌّ واحد:
هذه الكلمات التي تُعتبر أنها العقيدة الأساسية للإيمان بوحدانية الله في العهد القديم، لها مضمون عملي وآخر لاهوتي.
فلقد اكتشف الإسرائيليون المضمون العملي لهذه العقيدة عندما احتفلوا بخروجهم من أرض مصر أرض العبودية، فسبَّحوا هذه التسبحة: «مَن مثلك بين الآلهة يا رب، مَن مثلك معتزّاً بالقداسة» (خر 15: 11)؟ وهو سؤال يفيد أنه لا يوجد إله مثل ”يهوه“ الرب إله إسرائيل. فقد عرفوا ورأوا في مصر آلهة كثيرة كان يعبدها المصريون، كلها أصنام وأوثان لم تستطع أن تنقذ المصريين من يد الرب إله إسرائيل الذي أخرج شعبه من أرض العبودية بذراع رفيعة: «يمينك يا رب معتزَّة بالقدرة، يمينك يا رب تحطِّم العدو» (خر 15: 6). فلقد اكتشف بنو إسرائيل تفرُّد إلههم واختبروا حضوره الحي في التاريخ، وقدرته العظيمة التي غلبت كل أعدائهم، وهكذا استطاعوا أن يدعوه ”الرب إلهنا“. فوحدانية الله وحقيقة وجوده صارت خبرة عملية لشعب إسرائيل.
ولكن هناك أيضاً المضمون اللاهوتي لهذه الكلمات. فهي تدل على أنها وحي مباشر من الله يُعلن وحدانيته ووحدته. فهو الله الواحد الذي إذا تكلَّم فليس هناك مَن يُناقض، وإذا وعد فليس هناك مَن يُبطل وعده، وإذا أنذر فليس هناك مَن يُقدِّم ملاذاً أو حماية من إنذاره. فهو ليس مجرد الأول بين الآلهة، بل هو الإله الواحد الأوحد، وهو بهذا الاعتبار الكلِّي القدرة. وقد قال الرب عن ذاته في ختام سفر التثنية: «انظروا الآن، أنا أنا هو وليس إله معي، أنا أُميت وأُحيي. سحقت وإني أشفي، وليس من يدي مخلِّص» (32: 39).
وقد امتلأت الأسفار المقدسة في العهد القديم من الآيات التي تشير إلى وحدانية الله وقدرته الكلِّية. وكأمثلة لذلك ما جاء في سفر المزامير:
+ «لا مِثل لك بين الآلهة يــــا رب... لأنــك عظيم أنت وصانع عجائب، أنت الله وحدك» (مز 86: 10،8).
+ «لأنه مَن في السماء يُعادل الرب. مَن يُشبه الرب بين أبناء الله. إله مهوب جداً في مؤامرة القديسين» (مز 89: 7،6).
وفي سفر إشعياء النبي:
+ «أنا الرب الأول، ومع الآخرين أنا هو» (إش 41: 4).
+ «أنا الرب. هذا اسمي، ومجدي لا أُعطيه لآخر» (إش 42: 8).
+ «أنا الأول وأنا الآخِر، ولا إله غيري» (إش 44: 6).
+ «اسمع يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخِر» (إش 48: 12).
وفي سفر إرميا:
+ «لا مِثل لك يا رب. عظيمٌ أنت وعظيم اسمك في الجبروت» (إر 10: 6).
أما عن قول موسى لبني إسرائيل: «اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا ربٌّ واحد»، فقد علَّق عليها كثيرون من الآباء المفسِّرين بأقوال متعددة ومضيئة، تشرح إيماننا بوحدانية الله مع اعتقادنا بالثالوث الأقدس كمسيحيين، نلنا استعلان هذا السر. فيقول القديس أمبروسيوس أسقف ميلان:
[هكذا كان أيضاً تعليم الناموس: «اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك ربٌّ واحد»، بمعنى أنه لا يتغيَّر. فهو باقٍ دائماً في وحدة القوة. فهو كما هو لا يعتريه أي تحوُّل إلى الارتقاء أو التصاغر. لذلك دعاه موسى أنه واحد](2).
ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم:
[قد يقول قائل: فماذا إذن؟ ألعل الذين عاشوا قبل مجيئه قد أخطأوا؟ كلاَّ، على الإطلاق، لأن البشر كان يمكنهم أن يخلصوا رغم أنهم لم يكونوا قد اعترفوا بالمسيح. لأن هذا لم يكن مطلوباً منهم، سوى أن لا يعبدوا الأصنام ويؤمنوا بالإله الواحد. فقد قيل لهم: «الرب إلهك رب واحد». لذلك فقد نال المكابيون الإعجاب، لأنهم من أجل حفظهم للناموس عانوا ما قد عانوه، وكذلك الثلاثة فتية. وكثيرون آخرون من اليهود قد عاشوا حياة فاضلة للغاية، وبمحافظتهم على المستوى المطلوب منهم للمعرفة، لم يَعُدْ عليهم من المتطلبات أكثر من ذلك. وهكذا، فقد كان حينذاك كافياً لخلاصهم - كما قلت - أن يعرفوا الله الواحد، ولكن الآن لم يَعُد الأمر هكذا. فإنه يلزم أيضاً معرفة المسيح](3).
أما القديس أغسطينوس فيشرح إيماننا المسيحي بالثالوث، وكيف أنه لا يتعارض مع إيماننا بالله الواحد، فيقول:
[فلنتأمل الآن ولو إلى وهلة تلك النصوص الكتابية التي تُلزمنا أن نعترف بأن الرب هو إله واحد، سواء سُئلنا عن الآب وحده أو عن الابن وحده أو عن الروح القدس وحده، أو عن الآب والابن والروح القدس معاً. فيقيناً إنه مكتوب: «اسمع يا إسرائيل: الرب إلهك ربٌّ واحد». فعمَّن تظنون قد قيل هذا؟ إذا كان هذا الذي قيل هو عن الآب فقط. إذن، فربنا يسوع المسيح ليس إله! فلماذا جاءت تلك الكلمات على لسان توما حينما لمس (جنب) المسيح فصرخ قائلاً: «ربي وإلهي»، تلك التي لم يستنكرها المسيح بل صدَّق عليها بقوله: «لأنك رأيتني (يا توما) آمنتَ»](4)؟
كما يقول القديس هيلاريون أسقف بواتييه (315-367م) مُعلِّقاً على نفس اعتراف القديس توما الرسول:
[دعنا نرى إن كان اعتراف توما الرسول يتفق مع هذا التعليم الذي للإنجيل، وذلك عندما قال: «ربي وإلهي». فهو، إذن، إلهه الذي اعترف به كإله. وهو بالتأكيد كان واعياً بما قاله الرب: «اسمع يا إسرائيل: الرب إلهك ربٌّ واحد». فكيف صار إيمان الرسول غير عابئ بالوصية الرئيسية حتى أنه اعترف بالمسيح إلهاً، بينما يجب علينا أن نحيا في الاعتراف بالإله الواحد؟ إن الرسول الذي أدرك الإيمان بالسرِّ الكامل من خلال قوة القيامة، بعد أن كان يسمع مراراً (قول المسيح): «أنا والآب واحد»، «كل ما للآب فهو لي»، «أنا في الآب والآب فيَّ»؛ اعترف الآن باسم الجوهر دون أن يُسيء إلى الإيمان (بالإله الواحد)](5).
ويعود القديس أغسطينوس ليؤكِّد أن إيماننا بالثالوث لا يتعارض مع إيماننا بالله الواحد، وذلك بقوله:
[إن الثالوث هو إله واحد، ليس فقط أن الآب والابن والروح القدس هم متماثلون في كل شيء؛ بل إن الآب هو آب، والابن هو ابن، والروح القدس هو روح قدس. وهذا الثالوث هو إله واحد، كما هو مكتوب: «اسمع يا إسرائيل: الرب إلهك هو رب واحد»](6).
ويوضح هذا القول أحد أساقفة شمال أفريقيا التابعين للقديس أغسطينوس، ويُدعى القديس فولجينتيوس (468-533م)، وكان أسقفاً لمدينة رسب (Ruspe)، حيث يقول:
[بما أنك تعلم أنك قد اعتمدت بالاسم الواحد الذي للآب والابن والروح القدس، حسب القانون الذي قرره مخلِّصنا، فاحفظْ هذا القانون بكل قلبك، من البداية وحتى النهاية، عالماً أن الآب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله. وهذا يعني أن الثالوث القدوس الفائق الوصف هو إله واحد بالجوهر، فهو الذي قيل عنه في سفر التثنية: «اسمع يا إسرائيل: الرب إلهك رب واحد»، وأيضاً: «الرب إلهك تتَّقي وإيـَّاه وحده تعبد» (تث 6: 13،4 حسب النص). وبلا شك... نحن نؤكِّد أن هذا هو الله الواحد، وهو وحده الإله الحقيقي بالجوهر، وليس هو الآب وحده، ولا الابن وحده، ولا الروح القدس وحده؛ ولكنه - في نفس الوقت - هو الآب والابن والروح. وهكذا فإنه يجب علينا أن نكون حذرين عندما نقول بالحقيقة إن الآب والابن والروح القدس هم إله واحد بقدر ما نُقرُّ بأنهم واحد في الجوهر. فلا ينبغي أن نقول أو نؤمن بشيء آخر خارجاً عن هذا الإيمان. (فهي هرطقة إذا قلنا) إن أقنوم الآب هو نفسه أقنوم الابن أو أقنوم الروح القدس؛ أو إن أقنوم الابن هو نفسه أقنوم الآب أو أقنوم الروح القدس؛ أو إذا تجرَّأنا وقلنا أو آمنَّا إن الأقنوم الذي يُدعى بالحقيقة الروح القدس في الاعتراف بالثالوث هو إما الآب أو الابن؛ فمثل هذا كله مرفوض](7).
أما القديس أثناسيوس الرسولي فيُثبت ذلك من قول الملاك للعذراء عندما بشَّرها بتجسُّد المسيح منها، فيقول:
[لا يمكن أن يتجزَّأ الثالوث، هذا نراه في ما قيل للقديسة مريم نفسها، فإن رئيس الملائكة جبرائيل لما أُرسل لكي يُعلن حلول الكلمة عليها قال: «الروح القدس يحلُّ عليكِ»، عالماً أن الروح القدس قائمٌ في ”الكلمة“. وبعد ذلك مباشرة يقول: «وقوة العلي تُظلِّلكِ (تسكن فيكِ)»، لأن المسيح هو قوة الله وحكمة الله (الآب)](8).
ثم يعود القديس أثناسيوس فيؤكِّد ذلك من أمر المسيح لتلاميذه بأن يذهبوا ويُتلْمِذوا جميع الأمم ويعمِّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي به نولد ولادة جديدة من فوق:
[لأنه كما أن المعمودية التي تتم باسم الآب والابن والروح القدس هي واحدة، لأنه يوجد إيمان واحد في الثالوث، هكذا أيضاً الثالوث القدوس هو متساوٍ في ذاته ومتحد بنفسه في وحدة غير متجزِّئة، والإيمان به إيمان واحد](9).
(يتبع)
(1) St. Ambrose, Duties of the Clergy, 1,2; NPNF 2,10:2.
(2) St. Ambrose, On the Holy Spirit, 3,14,105; NPNF 2,10:150.
(3) St. Chrysostom, Homilies on the Gospel of Matthew, 36; NPNF 1,10:150.
(4) St. Augustine, Letter 238; FC 32:201.
(5) St. Hilary of Poitiers, On the Trinity 7,12; FC 25:235-36.
(6) St. Augustine, Letter 238; FC 32:201.
(7) St. Fulgentius, To Peter on the Faith, 1,3; FC 95:61.
(8) (نقلاً عن كتاب: ”القديس أثناسيوس الرسولي“، للأب متى المسكين) - St. Athanasius, To St. Serapion 3:6.